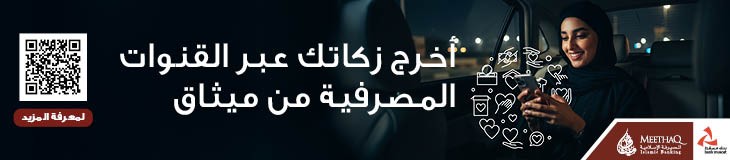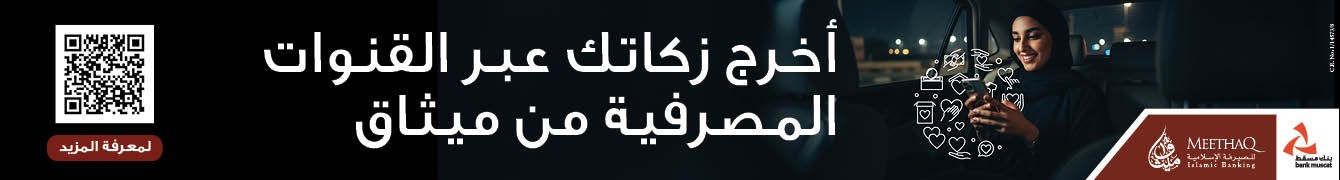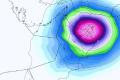صالح البلوشي
من ينظر إلى خريطة الوطن العربي يدرك أنها تمرّ بأسوأ حالاتها في تاريخها الحديث، إذ تكاد تفتقر إلى الاستقرار في معظم بلدانها. فالسودان، مثلًا تم تقسيمه قبل أن يدخل في حرب أهلية طاحنة، ولا يزال عاجزًا عن الخروج منها حتى اليوم. أما مصر، فتعيش أوضاعًا اقتصادية بالغة السوء، فضلًا عن ضغوط سياسية متزايدة بسبب رفضها مشاريع توطين الفلسطينيين في سيناء. وليبيا فحالها معروف للجميع، وكذلك اليمن، وموريتانيا، والصومال، التي تعاني من أزمات مزمنة ومتفاقمة.
وفي سوريا، وبعد حرب أهلية استمرت 14 عامًا، تبرز مخاوف جديدة من انزلاق البلاد إلى حرب طائفية، على ضوء المذابح والقتل على الهوية التي شهدها الساحل السوري، ثم السويداء لاحقًا، إلى جانب مناطق أخرى.
أما لبنان، فيواجه ضغوطًا أمريكية متواصلة لنزع سلاح حزب الله، رغم مرور تسعة أشهر على وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، الذي لا يزال يواصل اعتداءاته اليومية وسط صمت دولي غير مستغرب. فما أسباب هذا الضعف العربي؟ ولماذا أصبحت اجتماعات جامعة الدول العربية مجرّد مادة للتندر والسخرية في الشارع العربي؟
هل يعود ذلك إلى ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، الذي لم يأتِ بالديمقراطية المنشودة، ولا بالعدالة الاجتماعية التي كانت الشعوب تطمح إليها، بل أسهم في تقسيم ليبيا واليمن، وتدمير سوريا وتفكيك وحدتها الداخلية؟
أم أن الأمر نتيجة مباشرة للتحولات الإقليمية العميقة التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر، والتي قلبت ميزان العلاقات الدولية والإقليمية؟
أم أن المشكلة في الأصل تكمن في غياب الرغبة الحقيقية لدى بعض الدول العربية في التدخل في الشأن الفلسطيني، بسبب موقفها من حركة "حماس" التي تُعد امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما لا يلقى قبولًا لدى عدد من الأنظمة العربية؟
وسط هذا المشهد القاتم، يبرز السؤال المؤلم: دول تعاني من هذا القدر من التفكك والانقسام، كيف لها أن تمارس ضغطًا على الولايات المتحدة لإجبار الكيان الصهيوني على وقف مسلسل القتل اليومي وسياسة التجويع الممنهجة بحق المدنيين في غزة؟.. دول لم تستطع حل أزماتها الداخلية، فكيف لها أن تحلّ أزمة غزة؟
في زمن السقوط العربي الجماعي، لم يعد يُنتظر من الأنظمة أن تنقذ غزة أو أن تكبح جماح آلة القتل الصهيونية. لكن ما يجب ألّا يسقط بالتوازي هو صوت الشعوب، وضمير المثقفين، ووعي الأجيال.
ومع ذلك، فإن الواقع مؤسف إلى حدٍّ بعيد؛ إذ نشهد شبه غياب للمثقفين العرب عن المشهد الفلسطيني، وكذلك للإعلاميين والفنانين ومؤسسات المجتمع المدني. بل إن مواقف بعض المثقفين والإعلاميين كانت مخجلة، وذهب بعضها إلى حدّ التماهي مع الخطاب الصهيوني، وكأنهم باتوا أكثر تطرفًا من الصهاينة أنفسهم!
إن الصراع مع الكيان الغاصب ليس صراعًا سياسيًا أو عسكريًا فحسب، بل هو صراع وجودي؛ على الحق، وعلى الذاكرة، وعلى المعنى. وإن عجز النظام العربي الرسمي، لأسباب نعرفها جميعًا، عن ملء هذا الفراغ، فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المجتمعات العربية والإسلامية، لتملأ هذا الغياب بالكلمة، بالموقف، وبالحد الأدنى من التضامن، كي لا تتحوّل المأساة إلى مجرد خبر عابر في نشرة المساء.